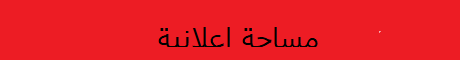بقلم: أحمد بدوي
في زحمة الحياة وضجيج المدن الحديثة، كثيرًا ما نغفل عن تلك الزوايا الدافئة في ذاكرتنا، حيث تختبئ البدايات الأولى. هناك، في طفولتنا، على تلك الأرض التي كانت مسرحًا لأحلامنا الصغيرة، كنا نركض حفاة على التراب، نلهو بلا قيود، ونرسم ببراءتنا عالمًا لا يعرف الحزن ولا الغربة.
ما أجمل الرجوع إلى تلك الأيام التي تخلّد في القلب مهما مرّ الزمن. فالأرض التي لعبنا فوقها ليست مجرد مساحة من التراب، بل هي قطعة من الروح، تربطنا بها علاقة وجدانية لا يمكن أن تنقطع. في كل ذرة تراب منها حكاية، وفي كل ركن ظلٌّ لذاك الطفل الذي كنّاه يومًا. تلك الأرض ليست وطنًا بالمفهوم الجغرافي فحسب، بل وطنٌ شعوريّ لا يمكن أن نغادره مهما ابتعدنا.
ومهما حملتنا رياح الغربة بعيدًا، يبقى الحنين هو ذلك الخيط الخفي الذي يشدّنا نحو الجذور. فالوطن ليس فقط ما نراه أمامنا، بل ما نحمله في داخلنا، في لغتنا ولهجتنا، في عاداتنا وتقاليدنا التي نشأنا عليها، في رائحة الخبز عند الصباح، وصوت الأذان من مئذنة الحيّ القديم، وفي ملامح الأم التي ما زالت تنتظر.
الأم تلك التي كانت فصلنا الأول في الوجود، من رحمها بدأنا الحكاية، وبحنانها تعلمنا معنى العطاء. هي الوطن الأول الذي لا يُهزم بالغياب. والأب، هو السند، عمود البيت، وقلبه النابض بالقوة والطمأنينة. أما الإخوة، فهم الامتداد الطبيعي لتلك الطفولة، الذاكرة الحيّة التي تختزن ضحكاتنا ومشاكساتنا وأحلامنا الصغيرة.
ومع دوران الأيام ومرور السنين، تبقى هناك مساحة في القلب للحب الأول، ذاك الذي يرفض أن يشيخ. ربما تغيّرت ملامح الحياة، لكن تظل النظرة الأولى، وتلك المشاعر البريئة، خيطًا رقيقًا يربط بين ماضٍ لا يُنسى وحاضرٍ يمضي سريعًا.
الزمن يمضي، والوجوه تتبدل، لكن هناك شيئًا واحدا لا يتغير ،الحنين إلى الوطن. إنه نداء داخلي لا يهدأ، شعور يرافقنا حيثما كنا، مهما تعددت الأماكن وتباينت الثقافات. فالوطن هو الأمان حين يضطرب العالم، وهو المأوى حين يشتد البرد في الروح.
فلنعلّم أبناءنا أن الوطن ليس فقط أرضًا وعلَمًا، بل هو هوية وانتماء، هو الذاكرة التي تحفظنا من الضياع. من ينسى وطنه، ينسى نفسه. ومن يحنّ إلى ترابه، لا يزال قلبه حيّا ينبض بالوفاء.
ما أحلى الرجوع إلى الماضي، ليس هروبًا من الحاضر، بل عودة إلى الأصل، إلى تلك الجذور التي منحتنا المعنى، وإلى ذلك التراب الذي علّمنا كيف نحبّ، وكيف نكون.